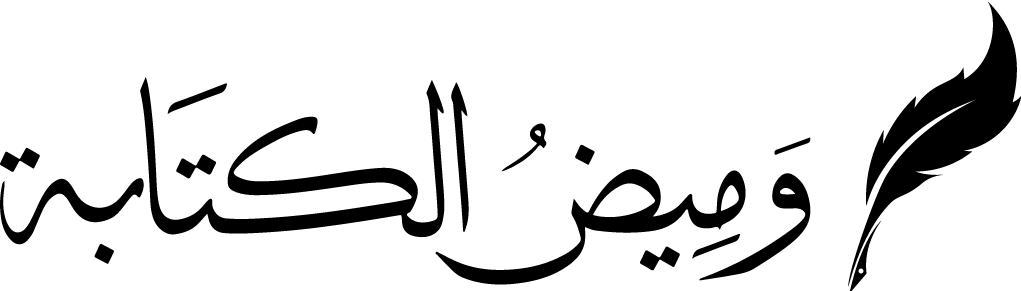كعادة كل عام يشتاق القلب لافريقيا وطوابعها ومعالمها العجيبة وتفرداتها الغريبة، أخذتُ نفسي سائراً إليها سير حبيب لمحبوبٍ طال غيابه وازداد شوقه، قبيل ظهر يوم السبت وصلت ولاية كانو والغيوم متلبدة في اجزاء السماء، الهواء بأنسامه العذبة ونسيم المطر يهفو على الموجودات بكل محبة، ليست المرة الأولى لزيارة كانو بل الرابعة لها، منذ وصولي لقيتُ أحبتي كما عهدتهم وعرفتهم بيُمنٍ وسلامة، توجهنا مباشرةً لتناول الغداء الافريقي المعهود، العصيدة بإيدام البامية المهروسة والعجين المكوّر الملسوق في الماء المسمى ( دواكي ) عجين معمولٌ من دقيق أبيض يُسلق بماء ويضاف عليه العطرون، يُسكب على الطبق ويوضع عليه البيض المسلوق للتزيين وشيء من السلطة الخضراء لمن أراد، ويُستلذّ به أكثر مع الفلفل الأحمر المطحون، وختام الغداء شربنا ( الفُرا ) لبن ودخن مطحون يضاف عليه السكر والماء، وهكذا كان غداءً مميزا، في متنصف العصر توارينا في مقهى لشرب الشاي الأحمر، والشاي الأحمر هنا يُشرب بحب وفناء، يحبونه بالقرنفل يعطيهم نكهة متميزة، ولمن أراد التمتع أكثر يضيف الليمون مع الشاي، لقيت من ضمن الجُلّاس خالد ولا أدري متى آخر مرة رأيته فيها، والده المعلم ثاني كان صديقاً حميماً لوالدي، أخذنا الحديث أنا وخالد في توردة الذكريات القديمة بين والدي ووالده، ذكّرني بكثير من اللحظات التي لا تُنسى ما حيينا، خطفنا الحنين لتلك المواقف والمشاهد الشيء الكثير، صداقة والدي ووالده أكثر من خمسين عام بلا انقطاع، حتى آخر أيامهما كان المعلم ثاني يزور والدي ويجلسان بالساعتين والثلاث ولا يتكلم احدهما بكلمة إلا القليل من السؤالات المعتادة، حتى صمتهما يفوح بعبير المودة والأُلفة، ومن عجيب أمرهما أن بين وفاتهما ستة أشهرٍ فقط، مات المعلم ثاني في منتصف شهر رمضان ثم والدي في منتصف شهر صفر، ومن اللطيف أن صحبتهما كانت في الحياة وبعد الوفاة كان قبرهما بجانب بعض، وباتفاقٍ سابق غادرنا صباح الاحد إلى ولاية لاغوس العاصمة الإدارية للبلد سابقاً، وما زالت تُعتبر العاصمة التجارية لجنوب البلاد، مركب سيرنا للاغوس حافلة من الحجم الكبير، الباص مملتئ وبعض مقاعد الجلوس اثنان يشتركان بقيمة مقعد واحد فالأول يجلس برهة من الوقت والآخر يفترش أرض الممر حتى يحين وقته في الجلوس على المقعد، ومثل هذا المنظر متعدد لمن كانوا عائلة، فالسفر براً هو للفقراء فقط فهذه الوسيلة التي يستطيعون دفع أجرتها للوصول إلى مقصدهم الآخر، قيمة المقعد إلى لاغوس ستة وعشرون ألف نيرا ما يعادل خمسة وستون ريالا، تحركنا الساعة الثانية عشرة ظهراً وامتطينا الطريق مستعينين بالله الحفيظ من كل شيء مخيف، كنت على استعداد نفسي بطول الطريق وبُعد المسافة وهذا مما يُخفف عناء السفر، أقبل الليل علينا والطريق لم نصل ثلثه بل وأقل من ذلك، من غير سابق إنذار تعطّل التكييف ولكن استغثنا بهواء الليل فكان يميل للبرودة كثيراً، منذ خروجنا من كانوا والطريق بأكمله يميناً وشمالاً ساحات خضراء والطبيعة بامتداد الأبصار والسماء بغيومها حجبت الشمس ﻷيام عن المظهر الوجودي، ننام قليلاً من الوقت ونستيقظ للمسامرة ونسيان كآبة الطريق، لم يكن الطريق معبّداً بكامله، فبعض أجزاءه تتطلب القيادة بمهل وتؤدة، القيادة هنا في افريقيا تتطلب التركيز وطول البال والصبر، أحد سائقي الباص يقود وكأنما يمتاط خيلاً لوحده، يتمارق في الطريق ولربما أَحسَنَ جودة القيادة باعتياده على السفر براً، كنتُ أقضي وقتي بين مشاهدة فيلم أو قراءة مقتطفات من كتب مكنونة في الهاتف، وبعض الوقت أقضيه متفكّراً في تفاصيل الحياة وترتيب الأفكار، ولكن ثمّة فواصل في الطريق وقيادة سائقنا الميمون لا يجدي بنا إلا التفكّر في المعاد وتجاوز الصراط وكيفية إحسان الجواب ﻷسئلة منكرٍ ونكير، أَهَلَّ علينا الصباح وما زلنا في طريق السفر تجاوزنا نصف المسافة وأكثر، بدأت أقدامنا تطلب التمدد والراحة فالجلوس الكثير أتعبها وأرهقها، الساعة العاشرة صباحاً دخلنا ولاية لاغوس بخير ولطف وعافية والكل بخير، اثنان وعشرون ساعة بتمامها وكمالها هي مدة سفرنا من الانطلاق وإلى الوصول، ولا اعتقد يتحمّل هذا كل أحد، فبعض المتاعب تتطلّب عزيمة قوية وإرادة عالية، خامسنا من رفقة الطريق هو سابق العيش هنا في لاغوس يعرف مداخلها ومخارجها وجميع أسرار تلك الولاية، وصلنا لفندق بسيط هو للنوم فقط لا لشيءٍ آخر، قيمة الليلة فيه عشرة آلاف نيرا ما يعادل خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، وضعنا أمتعتنا وخرجنا لرؤية تفاصيل لاغوس، وقفنا عند مطعمٍ كبير والنظام فيه صف متعدد الأصناف والاطباق مما يُشوى ويُطبخ ويُقلى، يأخذ الشخص طبعاً ويطلب من الأصناف ما أراد، وفي نهاية المطاف يُحاسَب على ما أخذ، ولا أحب هذا النوع من المطاعم فالعين تشتهي فيه كل شيء ويملأ الطبق تلو الآخر وعند التغذية فلربما يأكل نصف أو ثلثيه فقط، خرجنا متوجهين على الشاطئ كان الهواء فيه عذباً طرياً جلسنا فيه ساعات نهنأ بتفاصيل المكان وما حوى، وفي صبيحة اليوم الثاني خرجنا إلى حديقة يُوجَد بها معلَم شهير وهو الجسر المعلّق، قيمة تذكرة الدخول للحديقة خمسة آلاف نيرا ما يعادل اثنا عشر ريال ونصف الريال، دخلنا الحديقة وفي مقدمة مداخلها جماجمٌ حيوانية من أصغر حيوان ﻷكبره، جمجمة الفيل تُعرف بفتحات الانياب، وجمجمة الضبع مكثناً وقتاً حتى أُخبرنا بحيوانية الجمجمة، وللعلم: الضبع في افريقيا عموماً ذو حظوة عند بعض القبائل الغير مسلمة، يقتنونه للمباهاة والمفاخرة والاستفادة من جلده لصنع بعض الملبوسات، وأما لحمه فالبعض يطهونه كإيدام كما تُطهى لحوم الغنم والبقر بالإدام الأحمر، وأما قليل من الأفراد يقتنون الضبع للاستخدامات السحرية عافانا الله من هذا البلاء، جميع الجماجم التي رأيناها عند مدخل الحديقة هي للزينة فقط لا غير، بدأنا السير لمشاهدة معالم المكان فمشينا على صفيحٍ من خشب مسطّر مضمومٌ بعضه ببعض وعن اليمين والشمال الأشجار الكثيفة وعليها نوعٌ من القردة لا أعرف اسمه مخطط الرأس بالسواد سريع الحركة والدهاء، وتحت الأخشاب مستنقع مائي كبير مشينا على ذلك لمسافة ووصلنا الجسر المعلّق والمجموعات الزائرة تصعد الجسر متفاوتين، لم أكن على علم بتفاصيل الجسر المعلّق يبدأ تدريجياً بالصعود ﻷعلى قمته وأعلى الجسر يبعد مسافة بعيدة، مشيتُ عليه مغمض العينين في أكثره لأنه متعرّج ويتطلّب التركيز في كل حركة، مخيف لمن لم يعتاد القمم العالية ومثلي لم أعتاد ذلك وأشعر بالرهبة من هذه العوالي الشاهقة، أمشي في أعلى الجسر وكأني ذو التسعين عاماً أثقلته الهموم والغموم وتكاثرت على الأمراض والأوبئة، تذكرت وقتها شريط حياتي كاملاً كما لو متُ قبل هذا ولم أصعد، حتى صديقي وهو يمشي خلفي بأبطأ حركة وأشد تركيزا، تذكرنا سوياً الحساب الأخروي وشدته والصراط ودقته فتبنا حينها توبةً نصوحة عما سبق من أعمالنا الزائفة وذنوبنا السالفة، وسرعان ما نقضنا هذه التوبة حين وصلنا لمرفأ الامان بعد النزول من الجسر المعلّق لا أعادها الله من تجربة، بعد الاستراحة من هول الجسر أخذنا ثمرة الجوز الهندي وشربنا ماءها وأكلنا الاناناس وهو من أطيب الفواكه المنتجة في البلاد مع غيرها من الفواكه الكثيرة كالمانجو والقصب والعنب والليمون الافريقي، خرجنا للسوق الشعبي ففيه كل شيء يُباع من منسوجات وخردوات وملابس وما لا يخطر على بال، فولاية لاغوس ذات ميناء تجاري قديم وعريق تفد إليه السفن التجارية من مختلف الدول القريبة والبعيدة، وبما أنها مدينة تجارية فهي متعددة أعراق الشعوب والقبائل، يفد إليها الناس من كل حدب وصوب للتجارة والأعمال بمختلف أصنافها، وأنا في خضمِّ رحلتي هذه وصلني نبأ وفاة جارنا الميمون الشيخ عمر المعروف بيننا بمالم عمر، أتى مبكراً من كانو لمكة مجارواً لحين وفاته، كان مؤذناً بمسجد الحي ويصلي بنا حين تعذّر الإمام عن الصلاة، صوته افريقي لم يتغيّر في الكلام والتلاوة والأذان، يعجبني تمسكه بإفريقيته في كل شيء، وهو من أول مَن سمعته يقرأ برواية ورش عن نافع حينما يصلي بنا ويسدل يديه تبعاً لمالكية مذهبه، كان مسالماً مع نفسه ومع الآخرين ولم يتأذى منه أحد، جالت بي الذاكرة أذكر مشاهده معنا ومواقفه النبيلة وابتسامته التي لا تغيب عنا، صبيحة اليوم الثالث تجهزنا للعودة من حيث أتينا، ثلاثة أيام سريعة تجولنا في لاغوس ورأينا فيها ما يُعرف عنها حقيقةً لا ما يُشاع عنها، ليس من رأى كمن سمع وهكذا الترحال يُطلعك على أصالة الأشياء حلوها ومرّها والناس في كل مكان يعيشون كما يحبون وما تبتغي أحوالهم، الساعة الثالثة عصراً ركبنا الحافلة وهي أفضل من التي أتينا بها، في الصف الذي أمامي ثلاث سيدات كبيرات سن يتجاذبن الحديث بتفاصيله وأنواعه، لهجة حوارهن ذكرتني بصويحبات أمي وأحاديثهن التي لا تُمَل فيها من كل شيء، رحلة العودة أهون من الذهاب في أغلب التفاصيل، بين محطة وأخرى يصعد في الحافلة شخص ببضاعته يُتاجر بها ويسوّق بخبرته منتوجاته ويعرض شيئاً منها للناس للتجربة قبل الشراء، أحدهم يتاجر في العسل، والعسل الافريقي لذيذ المذاق حلو الطعم ولكن الغش في العسل أكثر من الغش في غيره، وأنا لا تمييز عندي بين سليم العسل وقبيحه، فأشتري الأرخص منه دوماً، والآخر يبيع أدوية شعبية ذات تجارب بين الناس، وهكذا دواليك حتى وصلنا لكانو بعد اثنين وعشرين سعاة في طريق السفر البرّي، وصلنا مرقدنا ونمنا نومةً هنيئة مريئة، عدنا لتجولنا صباح يومنا وحتى المساء سرعان ما عدنا لمنازلنا فحطت الأمطار أثقالها من بعد الغروب وحتى مطلع الشمس بلا توقف، فضل الله علينا لا يُعد ولا يحصى والحمد لله رب العالمين.